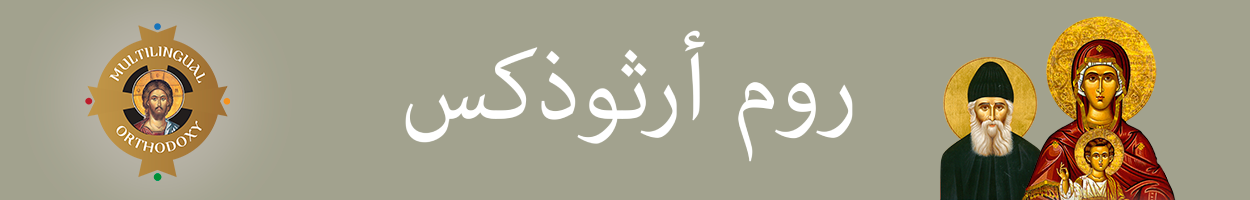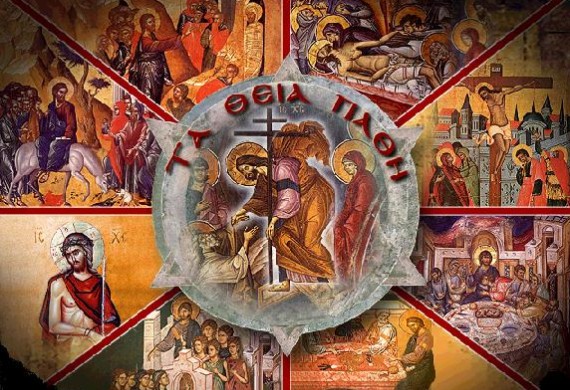ها قد بلغنا مشارفَ الأسبوع العظيم المجيد. ها قد جزنا الأربعين المقدّسة، مغتذين من المنّ النازل من السماء – كلمة الله المسموعة والمتناوَلَة؛ تتقدّمنا العذراءُ تابوتُ العهد، والعصا المفرعة، بمديحها الذي لا يُجلَسُ فيه؛ ويخطفنا داود بمزامير صلاة النوم الكبرى، ومنسّى في صلاته- توبته، من مشاهدات الدنيا، الى صومعة القلب، حيث نجوزُ صحراءَ سيناء العقليّة، نحو أقاصي دواخل قلوبنا. فالصوم هو حركةٌ نحو الداخل. رحلةٌ في الأبديّة، نترافق فيها مع «الطريق»، نحو «الطريق» (يوحنّا ١٤: ٦).
يُحكى عن الأب سيرابيون الصيدونيّ، وهو أحد آباء البرّيّة في مصر من القرن الرابع، أنّه ذهب مرّةً الى مدينة روما حاجًّا، وكان قد سمع عن معتزلةٍ تعيشُ في غرفة صغيرة، لا تغادرُها البتّة. بدا متحفّظًا تجاه اعتزالها، لكونه اعتادَ أن يجولَ دائمًا. فقرّر أن يزورَها؛ وسألها: «ماذا تفعلين وأنتِ جالسة هنا»؟ أجابته: «إنّني لستُ جالسةً، ولكنني سائرةٌ على الطريق».
المسيحيّ إذًا، كما يصفه الأسقف كاليستوس وير، هو الإنسان السائر على الطريق. حتّى وهو نائمٌ، يكون في حركة دائمة، «أنا نائمة، لكنّ قلبي مستيقظ» (نشيد الأناشيد ٥: ٢).
وهذه الحقيقة، عبّر عنها المسيحيّون الأوّلون بعمق كبير؛ فنرى في واحد من أقدم المؤلَّفات التي وصلت إلينا منهم، «تعليم الرسل الاثني عشر» (مطلع القرن الثاني)، صدى لهذه الرؤية. فنقرأ في مطلع الكتاب: «ثمّة طريقان: طريق للحياة، وطريق للموت. الفرق بين الطريقين كبير. طريق الحياة هو الآتي: أوّلًا «أَحببِ الربَّ الذي خلقك»، ثانيًا «أحبب قريبك كنفسك»… كنْ كاملًا… لا تكرهْ أحدًا. وبّخ البعض وارحمِ البعض، وصلِّ من أجل الجميع. أَحببِ الآخرين أكثر من نفسك». أمّا طريق الموت فهذا: إنّه شرّير مليء باللعنات والزنى، والفجور والرغبات والسرقة وعبادة الوثن…». ويُنهي الكاتب مقطعه، «احذر من أن يُضلّك أحد عن الطريق».
الطريقُ إذًا عندنا ليس وجهة، إنّه وجه. هو شخص. عبورٌ الى وجه يسوع. إصلاح ما قد فسُد، بتوبةِ مَن قد فسُد.
هو فرصةٌ نحياها اليوم، بصعوباتها وتحدّياتها. فرصةٌ للولوج إلى الداخل، لكي نرتقيَ بالداخل إلى فوق، «لنرفع قلوبنا إلى فوق» (مراثي إرميا ٣: ٤١).
هذه رحلتنا المبتغاة. رحلةٌ، انطلاقتها قرارنا؛ لوازمُها الكلمة وأصداؤها؛ وغايتها الكمال (متّى ٥: ٤٨).
في هذه الرحلة عراقيل وتحدّيات عديدة، أو أصنام، ينبغي لنا أن نهدمها، لنختبر الفصح، كما يشاؤه «حَمَلُ» الفصح (يوحنّا ١: ٢٩؛ ٣٦).
أوّلًا، صنم العادة، أي ألّا نحيا من العيد سوى عاداته؛ اللباس، الأكل والشرب والصور… فنعلق في قشور العيد ولا نختبر عمقه وجوهره.
ثانيًا، صنم العبادة، أي أن نحصر القيامةَ بالعبادة، أي في الطقوس والترانيم والصلوات والأصوام، من دون أن تساعدنا هذه على عمليّة تبدّلنا وتجديدنا «قلبًا نقيًّا اخلقْ فيَّ يا الله، وروحًا مستقيمًا جدِّدْ في أحشائي» (مزمور ٥٠: ١٢). فإن لم نتغيّر ونزد حبًّا لله وخَليقته، نكون في العبادة أو العادة لا في الحبّ، ولا يبدّلنا سوى الحبّ.
ثالثًا، صنم التاريخ، أي أن نعيّد وكأنّنا نحيي مجرّد تذكارٍ لقيامة المسيح قبل ألفَي عام، فنحصر القيامة في التاريخ.
وعتِ الكنيسة خطورةَ هذا الأمر، فشدّدت في أغلب ترانيمها على أنّ ما نختبره اليوم هو نفسه ما اختبره التلاميذ مع يسوع منذ ألفي سنة، لذا تراها تبدأ أعظم التراتيل بعبارة «اليوم». فـ «اليوم يُعلّق على خشبة…»، «اليوم يوم القيامة…»، «اليوم ستر الهيكل انشقّ تبكيتًا لمخالفي الناموس…»، «اليوم يهوذا يغادرُ المعلم ويتّخذ الشيطان…». فما صار مرّةً، نعيشُ نحن صداه – نعمَه وبركاته، كلّ يوم «ذوقوا وانظروا ما أطيبَ الربّ، لأنّه إذ قد صار سابقًا مثلنا لأجلنا، مقدّمًا ذاته مرّة واحدة قربانًا لأبيه، فهو يُذبح دائمًا مقدّسًا الذين يتناولونه» (من صلاة المطالبسي).
أمّا الصنم الرابع والأخطر، فهو صنم الأنا. فإن لم يكن صاحبُ العيد سيّدَ العيد وسيّدَ حياتنا وقلوبنا، وبقيت الأنا مركز حياتنا، ستكون حياتنا- طريقنا، نزهةً إلى اللامكان؛ مضيعة للوقت؛ خسارة للوعود.
تحطيمُ هذا الصنم قبل الفصح، يبدأ في الصَّفح. فمن لا يعرف الصَّفح، لن يعرف الفصح، «اليوم يوم القيامة، فسبيلنا أن نتلألأ بالموسم، ونصافح بعضنا بعضًا، ولنقلْ: «يا إخوة»، ولنصفح لمبغضينا عن كلّ شيء في القيامة…».
ما نحياه اليوم استثنائيّ. تاليًا، ما يجب أن تكون عليه تصرّفاتنا استثنائيّ أيضًا. فإن أردنا بصدقٍ أن نختبر فصحًا، علينا أن نختبر أوّلًا ما نصلّيه كلَّ يوم وبعد كلِّ طلبة، أي أن «نودعَ ذواتنا، وبعضنا بعضًا، وكلّ حياتنا، المسيح الإله».